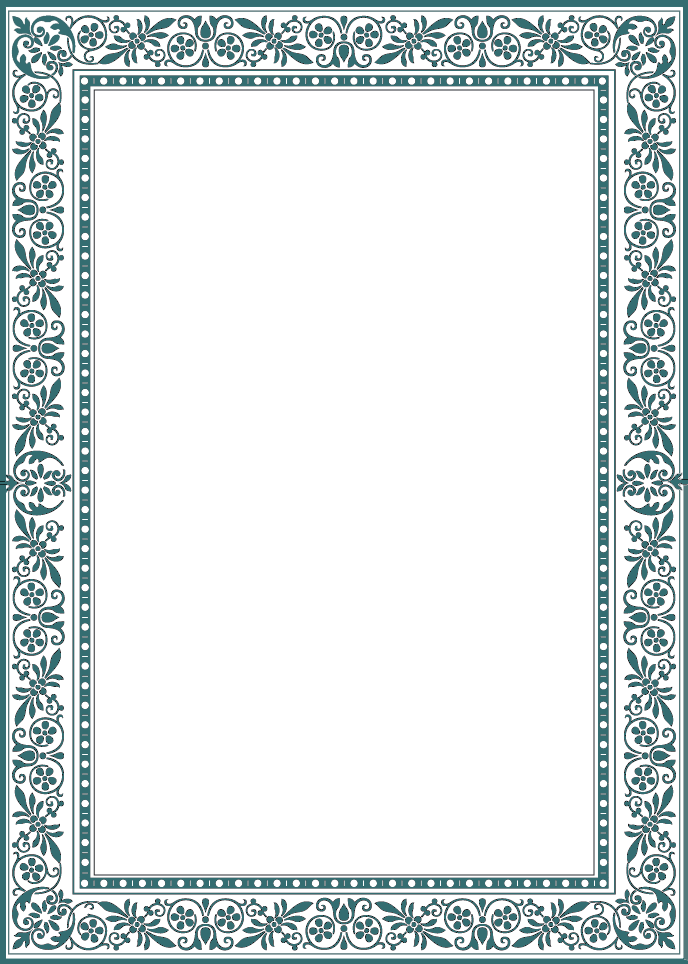
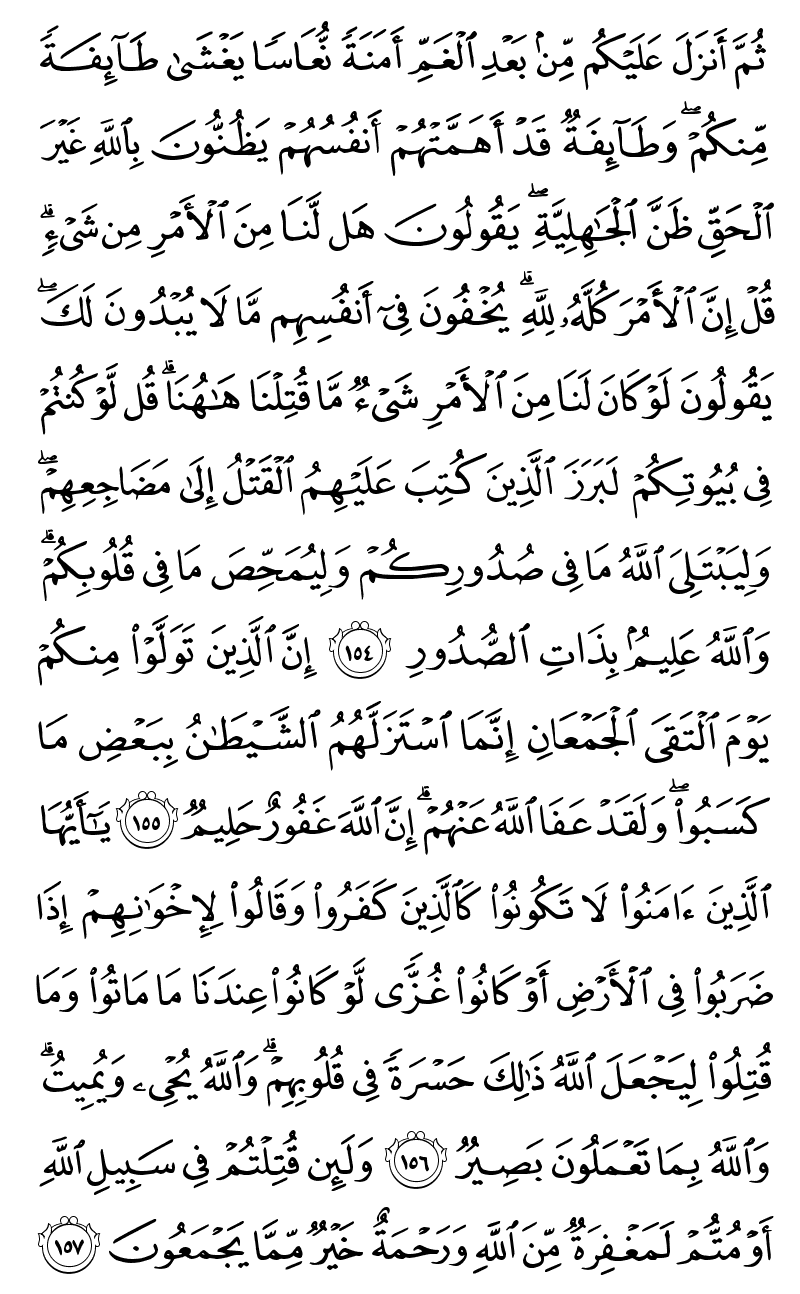

1
|
{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)} أخرج ابن جرير عن السدي. أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين، فواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدراً من قابل فقال لهم: نعم. فتخوّف المسلمون أن ينزلوا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: «انظر فإن رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم، وجنبوا خيولهم، فإن القوم ذاهبون. وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم، وجنبوا على أثقالهم، فإن القوم ينزلون المدينة. فاتقوا الله واصبروا، ووطنهم على القتال». فلما أبصرهم الرسول قعدوا على الأثقال سراعاً عجالاً نادى بأعلى صوته بذهابهم، فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فناموا، وبقي الناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم فقال الله يذكر حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم}. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهم، وإنما ينعس من يأمن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل عن المسور بن مخرمة قال: سألت عبد الرحمن بن عوف عن قول الله: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً} قال: ألقي علينا النوم يوم أحد. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، حدث أنه كان ممن غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، وسقط وآخذه. فذلك قوله: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم} والطائفة الأخرى؛ المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذ له للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كذبهم إنما هم أهل شك وريبة في الله. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه والحاكم وصححه وابن مردويه وابن جرير والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن الزبير بن العوّام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد إلا وهو مميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً وتلا هذه الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن الزبير بن العوّام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد إلا وهو مميد تحت حجفته من النعاس. وتلا هذه الآية {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً...} الآية. وأخرج ابن اسحق وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا} فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً} إلى قوله: {ما قتلنا ههنا} لقول معتب بن قشير. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم أنه قرأ في آل عمران {أمنة نعاساً تغشى} بالتاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود قال: (النعاس) عند القتال أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: إن المنافقين قالوا لعبدالله بن أبي وكان سيد المنافقين في أنفسهم قتل اليوم بنو الخزرج. فقال: وهل لنا من الأمر شيء؟ أما والله {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [ المنافقون: 8] وقال: {لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل}. وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع في قوله: {ظن الجاهلية} قالا: ظن أهل الشرك. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال معتب: الذي قال يوم أحد {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا} فأنزل الله في ذلك من قولهم {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله} إلى آخر القصة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: {يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك} كان مما أخفوا في أنفسهم أن قالوا {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا}. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال: لما قتل من قتل من أصحاب محمد أتوا عبدالله بن أبي فقالوا له: ما ترى؟ فقال: إنا والله ما نؤامر {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا}. وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل عن قوله: {قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم} قال: كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله، وليس كل من يقاتل يقتل، ولكن يقتل من كتب الله عليه القتل. |
|
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)} أخرج ابن جرير عن كليب قال: خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فلما انتهى إلى قوله: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} قال: لما كان يوم أحد هزمنا، ففررت حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى، والناس يقولون: قتل محمد فقلت: لا أجد أحداً يقول قتل محمد إلا قتلته، حتى اجتمعنا على الجبل. فنزلت {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان...} الآية. كلها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن عوف {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} قال: هم ثلاثة. واحد من المهاجرين، واثنان من الأنصار. وأخرج ابن منده في معرفة الصحابة عن ابن عباس في قوله: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان...} الآية. قال: نزلت في عثمان، ورافع بن العلى، وحارثة بن زيد. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} قال: نزلت في رافع بن المعلى وغيره من الأنصار، وأبي حذيفة بن عتبة، ورجل آخر. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} قال: عثمان، والوليد بن عقبة، وخارجة بن زيد، ورفاعة بن معلى. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان الذين ولوا الدبر يومئذ: عثمان بن عفان، وسعد بن عثمان، وعقبة بن عثمان، أخوان من الأنصار من بني زريق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن اسحق {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} فلان، وسعد بن عثمان، وعقبة بن عثمان الأنصاريان، ثم الزرقيان. وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى المنفى دون الأغوص، وفر عقبة بن عثمان، وسعد بن عثمان، حتى بلغوا الجعلب جبل بناحية المدينة مما يلي الأغوص فأقاموا به ثلاثاً، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد ذهبتم فيها عريضة». وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} ذلك يوم أحد ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه، فأنزل الله ما تسمعون أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفا عنهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {إن الذين تولوا منكم} يعني انصرفوا عن القتال منهزمين {يوم التقى الجمعان} يوم أحد حين التقى الجمعان؛ جمع المسلمين، وجمع المشركين، فانهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في ثمانية عشر رجلاً {إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا} يعني حين تركوا المركز وعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للرماة يوم أحد «لا تبرحوا مكانكم فترك بعضهم المركز» {ولقد عفا الله عنهم} حين لم يعاقبهم فيستأصلهم جميعاً {إن الله غفور حليم} فلم يجعل لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار كما جعل يوم بدر. هذه رخصة بعد التشديد. وأخرج أحمد وابن المنذر عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أخبره أني لم أفر يوم عينين يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر، فانطلق فخبر بذلك عثمان فقال: أما قوله أني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عني؟ فقال: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم}. وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم. ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله: إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأتاه فحدثه بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن رجاء بن أبي سلمة قال: الحلم أرفع من العقل لأن الله عز وجل تسمى به. |
|
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158)} أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض...} الآية. قال: هذا قول عبدالله بن أبي بن سلول والمنافقين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم...} الآية. قال: هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي {إذا ضربوا في الأرض} وهي التجارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: {لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} قال: هذا قول الكفار إذا مات الرجل يقولون: لو كان عندنا ما مات فلا تقولوا كما قال الكفار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم} قال: يحزنهم قولهم لا ينفعهم شيئاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن اسحق {ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم} لقلة اليقين بربهم {والله يحيي ويميت} أي يُعَجِّلُ ما يشاء ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته {ولئن قتلتم في سبيل الله...} الآية. أي الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله أو قتل {خير} لو علموا واتقوا {مما يجمعون} من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل لما جمعوا من زهيد الدنيا زهادة في الآخرة {ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون} أي ذلك كائن إذ إلى الله المرجع فلا تَغُرَنَّكم الحياة الدنيا ولا تغتروا بها، وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها. وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش أنه قرأ {متم} و {إذا متنا}. كل شيء في القرآن بكسر الميم. |
|
3:156 |